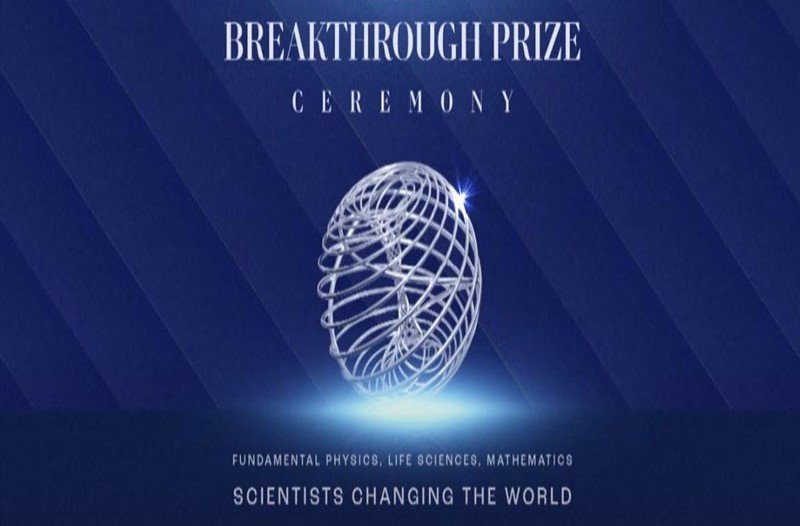إعادة النظر في العلاج النفسي: هل يحمل الماضي كل الإجابات
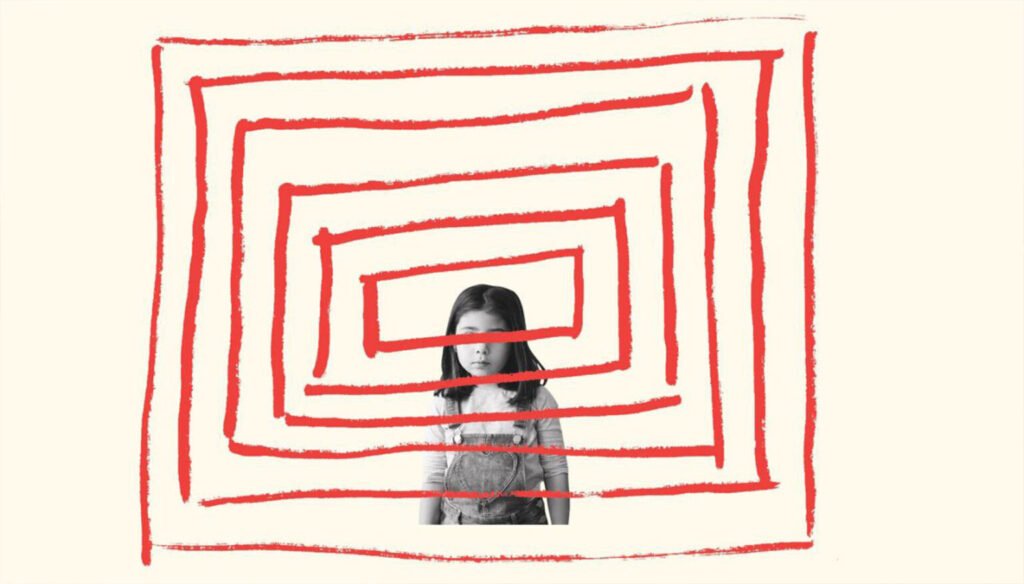

منذ آلاف السنين، يمارَس فن «الوجود من أجل الآخر»، الذي ينطوي على تتبع عوالم الشخص الآخر والاستماع إليه وفهمه. لطالما ناقش البشر حيواتهم وقيمهم ومشاكلهم في محاولة لإيجاد المعنى والعزاء والفرح. سُمّي خبراء هذا النوع من النقاشات بالنساء الحكيمات والشامان والكهنة، أما الآن فباتوا يسمون معالجين نفسيين. بدءًا من سيجموند فرويد، جاءت سلسلة من المحاولات لتحويل هذا الفن إلى علم للعلاج النفسي. لكنه ما يزال لا يحوي من العلم إلا القليل.
إن الوجود من أجل الآخر أمر صعب ومزعج ولا سلام فيه، خاصة وأن الآخر يتغير باستمرار. لكن هذا هو الفن فيه، والقيام بذلك على أكمل وجه يتطلب قدرًا من الخبرة والذكاء والحكمة والمعرفة. وبعيدًا عن بعض القواعد الأساسية لهذا الفن والتي يمكن التعرف عليها سريعًا، فإنه فنٌ لا يمكن تعليمه. من خلال مراقبة من يقومون به على أكمل وجه، خَلُصت إلى أن طرق إتقانه مبنية على رؤية آلاف العملاء وقراءة مئات الكتب في الفلسفة والفنون والعلوم وبعض الروايات الرومانسية الرخيصة. يتعزز هذا الفن عندما يصوّت ممارسه لِطَيف واسع من الأحزاب السياسية ويمارس عددًا من المهن، ويلتزم إما بدين واحد أو ثلاثة. فكيف يمكن فهم هذا الترقب أو الحماس أو الخسارة العميقة للمعنى في البحث عن الإله وإيجاده وفقدانه مرة أخرى ما لم تكن قد خضعت لشيء من هذا القبيل بنفسك؟
لقد أصبحت عالمًا ومعالجًا نفسيًا لزيادة الخير الذي أستطيع فعله في العالم. بدا واضحًا لي أن مساعدة الناس من خلال الانخراط في جذور معاناتهم ستكون من أكثر الأمور المفيدة التي يمكن القيام بها. وأصبحت أيضًا معالجًا نفسيًا للأطفال لمعالجة جذور هذه المعاناة في فترات الطفولة، التي بدا أن المعاناة تنبع منها. لقد شهدت إمكانية تحول المشاعر عند التعمق فيها، وتعلمت عن الصدمات التي تحدث قبل الولادة، حتى إنني كتبت أطروحة دكتوراه عن الصدمات. أما الآن وبعد عقدين من الزمن في مسيرتي المهنية، ما زلت أمارس وأحاضر وأشرف وأكتب عن كل هذه الأمور، لكن رفضي لكل ما تعلمته يزداد. بدلًا من ذلك، أمارس اليوم ما أسميه فن «الوجود من أجل الآخر»، وهي فكرة نشأت من محادثة مع زميلتي صوفي دو ڤيوپون. أنا الآن مرشد، وصديق في صداقات غير متكافئة، وموجه للحوار، وحليف ناقد يساعد الناس وهم يمرون بتعقيدات الحياة وعبثيتها وحطامها وأفراحها.
طوال هذه الرحلة وعلى مدار سنوات من الممارسة، فقدت الإيمان بأن الوعي بالمشكلة سيعالجها دومًا، وأن حل صدمات الطفولة من شأنه أن يحررنا جميعًا، وأن الإحساس الحقيقي بهذه المشاعر من شأنه أن يسمح لها بالتبدد. حصل ذلك من خلال حلقة معقدة من التغذية الراجعة في النظرية والممارسة.
بدأ ذلك بالعودة إلى اهتمام قديم بعلم الأحياء التطوري، مع نشر روبرت بلومين كتابه «المخطط الوراثي» (2018) الذي يتناول فيه دراسات عن التوائم، حيث يستند إلى عقود من الإحصائيات حول التوائم ومن عدة بلدان، وكانت الأرقام واضحة: نادرًا ما تؤثر أحداث الطفولة وأساليب التربية فينا إلى حد تشكيل ما سنغدو عليه في المستقبل.
دفعني ذلك لإعادة قراءة كتاب جوديث ريتش هاريس «لا اثنان متشابهان» (2006) الذي تناول أيضًا دراسات التوائم، إلى جانب دراسات واسعة النطاق أجريت على أنواع أخرى من الكائنات. رأت هاريس أن الدماغ عبارة عن صندوق أدوات صقلته عملية التطور لتقديم مجموعة من المهارات، الأمر الذي يجعل كل واحد منا فريدًا من نوعه تمامًا.
ولعل أفضل ما يلخص هذه الكتب هو القانون الثاني من علم الوراثة السلوكي، الذي يفيد بأن تأثير الجينات على السلوك البشري أعظم من تأثير البيئة الأسرية. هنا، لاحظت أن دفاعاتي بدأت بالظهور فجأة في محاولة يائسة مني في العثور على ثغرات في العلم. ولكن في نهاية المطاف، ودون انتقاء البيانات التي تتوافق مع ما تعلمته في تدريبي، كانت الحقيقة البسيطة بأن الأختين التوأم اللتين تحملان جينات متطابقة، وترعرعتا في أسر مختلفة تمامًا، طورتا شخصيتين متشابهتين للغاية، في حين أن الأختين بالتبني اللتين لا تربطهما أي روابط وراثية وترعرعتا في نفس الأسرة كانتا مختلفتين للغاية في شخصياتهما.
قوضت النتائج التي نشرتها مجلة «علم النفس التنموي» سنوات من التعلم في نظرية منهج العلاج النفسي الديناميكي. ما يعني أن تأثير البيئة الأسرية -سواء ترعرت على يد والدين حنونين أو متباعدين، أم نشأت لدى أسرة منخفضة الدخل أو مرتفعة الدخل- ليس مهمًا كثيرًا عندما يتعلق الأمر بشخصيتك. إذا كنت قد تلقيت أي تدريب في العلاج النفسي، فإن هذا يتعارض مع كل ما تعلمته.
ومع ذلك، لم تعكس مبادئ العلاج النفسي تجربة عملائي المعاشة، ولا حتى تجربتي الشخصية. ما يحصل هو أننا نرى ما نتوقع رؤيته، ونفهم ماضينا بناء على ما نشعر به الآن. فإذا كنتُ حزينًا، فسأتذكر الحرمان والصراع في طفولتي، بينما يتذكر شقيقي الأسعد مني موقفًا أكثر إيجابية؛ ولنتأمل هنا المذكرات المكتوبة مثل «الركض بالمقص» (2002) و«كن مختلفًا» (2011) و«الرحلة الطويلة إلى الوطن» (2011)، التي تعكس تصورات مختلفة جذريًا لعدة أشخاص من نفس الأسرة.
في الدراسات الطولية القليلة التي أجريت، والتي تتبعنا فيها الأطفال وتجاربهم السلبية في الطفولة منذ السنوات الأولى حتى مرحلة البلوغ، لم نجد رابطًا بين تجارب الطفولة السيئة واعتلال الصحة العقلية لدى البالغين. هناك فقط رابط بين اعتلال الصحة العقلية لدى البالغين و«تذكر» تجارب الطفولة السلبية. قد يبدو هذا مخالفًا تمامًا للمنطق في مهنة غارقة في نظرية الصدمة. حيث لم يثبت أن تجارب الطفولة السلبية تسبب اعتلال الصحة العقلية؛ بل إننا عندما نعاني كبالغين، نفسر طفولتنا على أنها كانت سيئة. أنا مقتنع بأن هناك استثناءات نادرة لهذه القاعدة، فهناك تجارب طفولة مروعة حقًا تترك ندوبًا، ولكن حتى هذا اليقين يتزعزع عندما آخذ في الحسبان حقيقة أن الأحداث التي يُفترض أنها تسبب صدمة لشخص واحد ضمن مجموعة تفشل في إحداث صدمة للآخرين.
إذا كنت ترفض ما كتبته للتو، فربما تفعل ما كان الأصوليون الدينيون يفعلونه منذ آلاف السنين. وقد يبدو ما أقوله قاسيًا أو باردًا أو سامًا سياسيًا، لكن المشاعر ليست أساسًا معرفيًا صالحًا لرفض المعلومات.
في المقابل، فلنفكر فيما يلي، يمكننا الاهتمام بالمعاناة ونحن نعيد تقييم تحليلنا حول كيفية حدوثها وكيفية علاجها، وربما تكون غالبية التدريبات العلاجية خاطئة فيما يتعلق بمعاناة البشر. فالناس في الثقافات الأخرى والذين لديهم وجهات نظر عالمية مختلفة جذريًا حول كيفية تطور المعاناة وما هي أفضل السبل للتعامل معها يهتمون أيضًا بمساعدة الآخرين، لكنهم ببساطة لديهم طرق مختلفة للقيام بذلك.
نحن بحاجة إلى إعادة النظر في أسباب معاناة البشر من أجل مساعدتهم على نحو أفضل. يخبرنا فرويد ومناصرو الصدمات النفسية الأكثر حداثة مثل غابور ماتي أن شخصياتنا ومعاناتنا تنبع من الطريقة التي عوملنا بها عندما كنا أطفالًا. وقد يتردد صدى هذه الفكرة في أذهاننا، ولكنها قد تكون في واقع الأمر خاطئة. وإذا كانت خاطئة، فقد تكون علاجاتنا عديمة الجدوى إلى حد كبير وربما ضارة. نحن في حاجة إلى فحص هذه النظريات بعين نقدية وبعناية أكبر قبل أن نتسبب كممارسين للعلاج النفسي بالمزيد من الأذى.
تاريخيًا، وفي العديد من الثقافات حول العالم من نيجيريا إلى ماليزيا أو حتى في الغرب منذ أكثر من 50 عامًا، كان ينظر إلى فترات الطفولة على أنها مرحلة من المراحل التي نمر بها، ولا تحظى بأي مكانة مقدسة، فنحن نتعلم طوال الوقت ولكن تنبع معاناتنا من كيفية تعاملنا في الوقت الراهن والآني مع العالم وماهية ظروفنا الحالية.
أليس من الغرور أن يفترض الكثيرون في الغرب أن هذه النظرية الجديدة غير المستندة إلى براهين -بأن مرحلة الطفولة هي منبع المعاناة- يجب أن تعمم صحتها عالميًا، أو حتى أن تكون صحيحة بالنسبة إلينا؟ كيف يمكن للمعالج النفسي، الذي يتبع منهج التحليل الديناميكي، في مواجهة عميله الذي يعاني، أن يتقين من ضرورة استحضار ماضيه خلال العلاج، في حين تقول التقاليد الفلسفية من مختلف أنحاء العالم إن الإجابة تكمن في الحاضر؟
لم يذكر بوذا ولا لاوتسي ولا المسيح كلمة واحدة عن ندوب الطفولة العميقة وتأثيرها على الوضع البشري، لقد نظروا إلينا كأفراد نحيا خياراتنا في الراهن. وبعد ألف عام، ما تزال أعمال الغزالي وتوما الأكويني تتحدث عن الآني، وحتى قبل قرنين من الزمان لم يكن هيجل وسورين كيركيجارد وويليام جيمس مهووسين بالطفولة.
إذا كانت أحوالنا ممتازة الآن، وإذا كانت العلاجات التي ندفع من أجلها الكثير من الأموال ناجحة كما تدعي، فلربما كنا سنشعر بمزيد من الثقة لرفض ما سبق. ولكن هذا ليس صحيحًا، حيث تشير المسوحات حول السعادة بأن العديد من النساء الغربيات، وهن الفئة الديموغرافية الأكثر لجوءًا للعلاج النفسي، لسن في حال ممتاز.
في البداية لم أتمكن من قبول هذه الفرضيات، إلى أن تعثرت بكتاب أبيغيل شراير «العلاج السيء»، الذي تصف فيه كيف تمارس الثقافة العلاجية تأثيرًا سامًا وضارًا في كثير من الأحيان على الثقافة ككل. لقد عملت مع الأطفال، ولكن هل كان العلاج النفسي الديناميكي (حيث نناقش الماضي) مفيدًا لهم حقًا؟ لا تستبعد شراير الفائدة العرضية التي قد تعود على الأطفال من التحدث إلى البالغين، ولكنها تسلط الضوء أيضًا على المخاطر التي قد تترتب على تحويل هذا إلى علاج روتيني.
إن الأطفال -أكثر من البالغين- يتحولون إلى ما يركزون عليه. إذا كان التركيز منصبًا على المشاعر الصعبة، فإنها ستتضخم بدل أن تتناقص. هذا هو ما يركز عليه العلاج النفسي للأطفال بجعلهم يلاحظون مشاعرهم الصعبة ويتحدثون عنها على أمل عبثي في أن تختفي كل هذه المشاعر بطريقة سحرية. تتوافق تجربتي مع البحث الذي استشهدت به شراير بأن الأطفال أكثر عرضة بكثير للتماهي مع مشاعرهم والوقوع في فخ الضيق المتزايد باستمرار.
اجعل طفلًا يعبر عن قلقه وهو يلعب خارج المنزل -كما تعلمتُ أن أفعل- ودعه يصف المكان الذي يشعر فيه بالقلق في جسده أو دعه يصف كيف تبدو الوحوش المخيفة في كوابيسه، وقد تشعر بأنك تساعده في استكشاف مشاعره، لكنه سينتهي به الأمر إلى الانغماس فيها أكثر ليصبح أكثر قلقًا مما كان عليه.
هناك تقنيات محددة للتعامل مع القلق الاجتماعي والرهاب ونوبات الهلع، وتعتمد مثل هذه التقنيات البسيطة التي تندرج اليوم تحت مظلة العلاج السلوكي المعرفي على الحكمة البوذية والفلسفة الرواقية والأفكار التقليدية من أجل الولوج إلى عقولنا عندما ننجرف إلى أماكن مظلمة داخلنا. ولكن لماذا نطالب الأطفال التعمق في مشاعرهم السيئة؟ إن هذا يعطل العملية الطبيعية للتكيف في مواجهة الشدائد واستكشاف الجانب الإيجابي فيها.
لا تكمن المشكلة فقط في الأساليب العلاجية التي تدرسها الجامعات، بل يتعين علينا أن ننظر إلى هذه المشكلة باعتبارها فكرة ثقافية أوسع نطاقًا تتسرب عبر التربية. يُنظر إلى المشاعر باعتبارها مركزية، في حين أنها في واقع الأمر مجرد تقديرات مبهمة وعابرة لموقف ما، والهدف الكامل من تربية طفل هو دعم وتطوير وظائفه التنفيذية حتى يتمكن من تنمية قدراته العاطفية والفكرية عندما يصبح بالغًا. وهذا يعني تعليمه أن مشاعره لا تمثل بالضرورة واقع الأمور، وأنه قد يصبح رهين مشاعره إذا لم يتعلم كيفية تجاوزها. بالتالي، لا ينبغي دومًا احترام غضب الطفل، وبالتأكيد لا يجب مكافأته على سلوكه الصعب الناجم عن الغضب عبر ترتيبات خاصة.
على سبيل المثال، تواصلت معي عائلة جيم في حالة من القلق بشأن عجزهم المتزايد عن التعامل مع سلوك ابنهم. لقد كانوا عطوفين للغاية، وبدأوا يلاحظون أن ابنهم يكافح لتنظيم اندفاعاته بنفسه ويهاجم الأطفال الآخرين. لذلك، طلبوا المشورة المهنية من معالجة ذي خبرة، أوصتهم بالجلوس مع جيم والسماح له بالتعبير عن مشاعره بأمان، وهو ما يعني غالبًا أن جيم سيقوم بمهاجمتهم.
وعندما لم تساعد هذه المحاولات، وبدأ جيم يقع في مشاكل في المدرسة، أوصت معالجتهم باتباع مقاربة علاجية قائمة على الصدمة، فقد فقدت الأسرة فردًا عزيزًا عندما كان جيم صغيرًا، وهو ما يُنظَر إليه الآن باعتباره السبب وراء اضطراب نمو جيم العاطفي، وكان غضب جيم مفهومًا في سياق ما حدث، وكان بحاجة إلى أن يكون حرًا في التعبير عنه. استلزم التعامل مع السلوكات القائمة على الصدمة التأكد من أن جيم يشعر بالأمان عندما يكون مضطربًا (وهي طريقة ملطفة لوصف صراخه وضربه وركله الناس)، ثم سؤاله عما يحتاج إليه، وإظهار المودة له وإيجاد أنشطة يستمتع بها مثل ألعاب الفيديو لإعادة التواصل معه. وبعد ذلك، يمكنهم سؤال جيم عن مشاعره.
تبنت مدرسة جيم استراتيجية مماثلة، حيث كان هناك موظف لدعم الطلاب متواجد دائمًا للعب معه عندما يزعج الفصل. وكانت الفكرة هي أن تكوين علاقات ارتباط قوية مع مقدمي الرعاية في المدرسة من شأنه أن يساعد جيم على الشعور بالأمان العاطفي، ومن ثم يتحسن سلوكه.
أوضحت لي والدته وهي تبكي أن أيًا من هذا لم يحدث، لقد طُرد مؤخرًا من المدرسة ويرفض الآن العودة إليها.
لم تكن هذه النظريات عشوائية أو غريبة، فأدبيات العلاج النفسي حول التعلق والصدمة واسعة النطاق وشائعة، بل لدى العديد من المدارس والمتخصصين في الصحة العقلية تدريب إلزامي على هذه الأساليب، ولكنها لم تنجح أيضًا. فبعد تشجيع جيم على تحديد غضبه والانغماس فيه أكثر بدل تشجيعه على المضي قدمًا لتجاوزه، كانوا كأنهم يعلمونه -من غير قصد- أن الغضب أو العنف في الفصل الدراسي من شأنه أن يمنحه تصريحًا مجانيًا للعب كرة القدم بدل دراسة الرياضيات. ورغم وجود والديه المراعين والمهتمين، كانت النتيجة انجراف جيم أكثر وأكثر إلى أطراف العالم الاجتماعي، لأن الهوس العلاجي بالتحقق من صحته العاطفية منعه من تعلم القواعد الاجتماعية التي تسمح لنا بالمشاركة فيها.
أكثر فأكثر، يبدو أن الافتراض الأساسي للعلاج النفسي للأطفال -وهو مساعدتهم على استكشاف المشاعر الصعبة- يتسبب بإحداث ضرر ذو منشأ طبي، أي أن العلاج نفسه ضار لهم. لذا، بدأت أرفض العمل مع الأطفال وأعرض العمل مع الآباء والشبكة الأوسع المحيطة بالطفل.
تستند الأخلاق الغربية في جذورها على الأمثولات الإغريقية والمسيحية القديمة حول الفضيلة والتواضع والتفكير النقدي، وهي تشكل جوهر التفكير في العلاج النفسي الحالي، ولكنها أصبحت أكثر اضطرابًا. فقيمتا الفضيلة والتواضع اللتين كانتا من متطلبات الوجود من أجل الآخر، أصبحتا مشوهتين على حساب صورة الضحية للمريض وهوية المنقذ البطولي للمعالج النفسي. في حين أصبح التفكير النقدي في الواقع بمثابة إسكات لأي نقد للدوغما العلاجية أو الإيديولوجية الحالية.
نحن نحب أن نرى أنفسنا كمفكرين نقديين، لكن الفكر النقدي لا يشير أبدًا إلى أن حوالي 10% من المرضى تسوء حالتهم بعد بدء العلاج. في هذه الحالات، قد لا يكون العلاج غير مفيد فحسب، بل قد يكون ضارًا أيضًا. إذا قيل لك إن عليك الاستماع إلى مشاعرك المؤقتة والذاتية من الانزعاج والأذى، وأن تنظر إليها باعتبارها حقيقتك، يصبح تجاوز هذه المتاعب الشخصية البسيطة مع الوقت أصعب. وإذا قيل لك إن مشاكلك في العلاقات تنبع من فشل والديك في الحضور الكامل من أجلك وتلبية احتياجاتك في مرحلة الطفولة، فإن الخطر يكمن في أن تصبح أكثر انتقادًا لعلاقتك بهما في حين ربما تكون في أشد الحاجة إلى تلك الرابطة الأسرية المتينة. لقد قطع أكثر من ربع الأميركيين علاقاتهم بأحد أفراد الأسرة؛ ومن غير المرجح إحصائيًا أن تكون أغلب حالات الاغتراب هذه بسبب نوع من الإساءة الصارخة التي قد نتصور أنها تستحق ذلك.
لا يتم الحديث عن هذا أو تدريسه أو البحث فيه في مؤسساتنا. تخيل لو جرى تمجيد فضائل الرأسمالية أو وسائل الإعلام الاجتماعية، ولم يفكر أحد قط في جوانبها المظلمة؟ في مهنة تمنح الكثير من الجهد والوقت لأفكار فرويد وكارل يونغ، يجب أن نكون هذه الجوانب المظلمة محور جهودنا، ومع ذلك فإننا نفشل في النظر لهذه الجوانب المظلمة الكبيرة لمهنتنا، التي تتمثل في أننا نتسبب باستمرار بإحداث الضرر.
هذا الافتقار إلى النقد الذاتي، إلى جانب الشعور بالفضيلة المعصومة من الخطأ، يخلق حماسة لنشر المقاطع الفكاهية غير المستندة لأدلة والتي قد تكون ضارة، من ثقافة العلاج النفسي إلى الثقافة السائدة. نرى هذا عندما يفسّر الضيق النفسي على أنه رد فعل على الصدمة أو بفعل الآباء الذين أخطأوا في حقنا بطريقة ما. ونراه في المدارس حيث يحصل الأطفال -الذين قد يفيدهم الوضوح ورسم الحدود أكثر- على استثناءات بسبب المقاربات العلاجية القائمة على الصدمة، والتي تمنعهم من الحصول على الدعم لتطوير المهارات السلوكية والحياتية التي سيحتاجون لها للمضي قدمًا في عالم البالغين.
إن نظريات الصدمة الزائفة تقنع قطاعات كاملة من المجتمع بأنها محطمة بشدة وتحتاج إلى خدماتنا العلاجية. كيف نجرؤ على الاعتقاد بأن الثقافات الأخرى أساءت فهم كيفية عمل المعاناة، بل وحتى ثقافتنا، حتى مجيء فرويد؟ لا يرى السيرلانكيون الحرب الأهلية أو حدوث كارثة تسونامي على أنها أحداث صادمة. فعندما ذهبت مجموعة من مستشاري الصدمات إلى سيريلانكا بعد تسونامي عام 2004 ، ناشدتهم جامعة كولومبو بالتوقف عن النظر إلى المعاناة على أنها صدمة لأنها تقوّض قدرة الناس على الصمود. ويصادف أن تتصدر سيريلانكا قوائم الرفاهية في تقرير الحالة العقلية للعالم في عام 2023 رغم هذا الإنكار لعقيدة الصدمة.
لا توجد ثقافة أخرى أعرفها تعتقد أن الأحداث السيئة تخلق ندوبًا لا تنسى في نفوسنا، ندوبًا تلوث إلى الأبد تجربتنا في العالم. حصلت أحداث سيئة على مر الزمن وكانت ولا تزال سيئة بما يكفي، ولكن دون الاستمرار في الإصرار على أن بعض الصدمات تعيش في الجسد بطرق لا مفر منها. إن إخبار الناس بأنهم تعرضوا للأذى إلى الأبد في حياتهم يخلق الاستياء ويضر بالعلاقات. وإذا كنت تروج لمثل هذه القصص، أو تصدقها ببساطة، فخذ بعين الاعتبار القراءة عن هذا العلم الهش الذي بنيت عليه هذه النظريات. فبينما يتحدث العلاج النفسي عن الكفاءة الثقافية والتعلم من طرق التفكير الأخرى، فإنه نادرًا ما يطبق هذا الكلام. يمكننا أن نتعلم من وجهات نظر الثقافات غير الغربية بشأن المعاناة، حيث نبقى في الوقت الحاضر، ونعاني في الوقت الحاضر، ونشفى في الوقت الحاضر.
هل من الخطر تطبيع العلاج النفسي باعتباره الطريقة المفضلة للتعامل مع الصعوبات؟ العلاج النفسي هو علاقة شبه اجتماعية، وشكل من أشكال الصداقة غير المتكافئة. إن المكون العلائقي لكونك معالجًا يشبه كونك عاملًا في مجال الجنس حيث توجد هناك علاقة، لكنها تتمحور بالكامل حول إرضاء العميل. إن قواعد الدفع وحدود العلاقة تجعلها تميل نحو العميل، فهي تتعلق بهم لأن المعاملة بالمثل قد تم دفع ثمنها. في عالم وحياة مثاليين، لن تكون هناك حاجة إلى عاملين في مجال الجنس ولا حتى للمعالجين النفسيين، لأننا جميعًا سنحظى بعلاقات جنسية وغير جنسية جيدة، ولكن في العالم الحقيقي لا يكون مثل هذا الخير متاحًا دائمًا. لذا يتدخل المعالجون النفسيون لسد الفجوة، وتقديم الخبرة في العلاقات ضمن مجالاتهم الخاصة، على أمل أن يسمحوا للعميل بتعلم ما يكفي عن نفسه والآخرين للذهاب إلى العالم الحقيقي وإيجاد علاقات حقيقية أفضل.
يكمن الخطر عندما تصبح العلاقة العلاجية بديلًا للعلاقات الحقيقية، أي عندما يجري تشجيعنا على تلقي العلاج النفسي بدل محاولة الانخراط مع الأسرة أو الأصدقاء في مسائل مؤلمة وحساسة. إن العلاقات الحقيقة تتطور عبر مناقشة القضايا الخلافية الحساسة والتي تقع على حواف المتفق عليه اجتماعيًا.
لا ينبغي للفضاء العلاجي أن يعزل العلاقات الخارجية الحقيقية عن العلاقات الداخلية المظلمة والفوضوية التي نحياها. ينبغي لهذا الفضاء العلاجي في بعض الأحيان أن يعيننا على احتضان الصعوبات وتدبيرها وتوضيحها بشرط استحضار نية واضحة لإعادة العميل إلى العلاقات في العالم الحقيقي.
أحالني كل ذلك إلى إشكالية ممارسة هذه العقلية الجديدة في النظر إلى الأمور. هل كان من الممكن التوفيق بين مشاكل العلاج والاستمرار في ممارسته كمعالج؟ إنه عمل قيد التقدم وهذه هي الحلول غير الكاملة التي أقدمها. لم يَعُد موقعي على الإنترنت يَعِد بالعلاج ولا يتباهى بتدريبي المكثف في هراء العلاج النفسي الديناميكي. إنه يقدم فقط مناقشات حول الحياة، مناقشات بدت مفيدة للعملاء في الماضي، وقد تكون مفيدة الآن، وبلا وعود.
أحاول أن أستعين بمصادر خارج فقاعة الفكر الغربي التي سادت على مدى خمسين عامًا، فالأفكار التي تظل قائمة وتتجاوز الثقافات تميل إلى ذلك لأنها ذات قيمة. تقدم لنا البوذية رؤى ثاقبة في اليقظة الذهنية، وخاصة إذا تذكرنا جميع جوانبها الثمانية، والتي تشمل الجهود والأفعال والخطاب. براجماتية ويليام جيمس، وأفكار فريدريك نيتشه عن الإرادة والاختيار، وأسلوب سقراط في الحوار، كلها حاضرة في ذهني وفي علاقاتي العلاجية، ولكن في النهاية من يقود هذه العملية هو العميل. إنها نقاشات حول حياتهم والمعاني التي يرنون إليها وكيف يعيشون هذه المعاني. إنها احتفال بالأشياء الجيدة ومكان لتسمية الأشياء السيئة، ولكنها في المقام الأول مساحة يتم التركيز فيها على الحاضر والمستقبل. أرى أن وظيفتي هي تجلية الأخلاقيات والجماليات لدى عميلي، وعندما نتحدث عن الأخلاق، فأنا في الواقع أعتقد أننا نؤسسها على الجماليات بحيث أن ما يبدو أنيقًا وصحيحًا بالنسبة لنا هو عادة ما يرتدي لاحقًا ثوب الأخلاق الرفيعة.
أعتقد أن العمل العلاجي الحقيقي يكمن في محاربة السخط. فالسخط هو جوهر جميع العلل وليس الألم في حد ذاته. ينشأ السخط عندما نكون في ألم ولكننا نعتقد أننا لا نملك الحق في الشعور بالألم. إنه هذا أمر من الصعب الانخراط فيه، خاصة وأنه يقع على حدود الحقوق والسياسة. فإذا شعرت أنني أملك الحق في نشر هذا المقال في صحيفة نيويورك تايمز أو أنني أملك الحق في ألا تتم الإساءة لي من المراجعات النقدية له، فإن الألم الناتج عن رفض صحيفة نيويورك تايمز وقراءة التهجم الشرس على حكمتي الحصيفة سيتضاعف إلى ما لا نهاية. إن استحقاقي سيجعل آلامي الأساسية أسوأ بكثير. ولذلك أعتقد أيضًا أن التسامح والامتنان هما أعظم حليفين لدينا لمحاربة الاستحقاق والاستياء ويمكن تطويرهما بسهولة.
لاحظوا أنني كتبت بأنني أؤمن بصحة ما سبق، لكنني غير متيقن من صحته. إنه ينجح بالنسبة لي، ويتردد صداه في نفسي، وقد كان موضوعًا لمنظرين دينيين وغير دينيين من سيدهارتا غواتاما ويسوع الناصري إلى نيتشه. لكن بساطة النظرية تسمح لعميلتي بمعرفة ما إذا كانت تنطبق عليها أم لا. وإذا أصرت عميلتي على أن التفكير القائم على الحقوق يمكن أن يتآلف مع الامتنان، فقد أتعلم منها.
بعد أن تخليت عن النظريات الفارغة وأبلغت عملائي بأنني لن أتمكن من التوصل إلى حلول سحرية من جانبي، وأن حياتهم هي مسؤوليتهم، وجدت نفسي متجذرًا في آلاف السنين من الحكمة، منتسبًا لأناس يقدمون الركائز في كيفية العيش. بوسعي الآن أن أتكئ على عملائي وأن أكون فضوليًا بشأن قصصهم، وأن أشارك في معضلاتهم، وأن أتعمق في عوالم حياتهم كمستكشف شجاع لا يترك حجرًا على حجر. فمن ناحية، أشعر بأنني أقل عبئًا بالمسؤولية لأنه لا ينبغي لي أن أفعل شيئًا، ومن ناحية أخرى، أصبحت المسؤولية أعظم لأنني أتحمل كل ما يتعلق بالعميل دون الاختباء وراء عدسة النظرية. لقد تخليت عن نظرية العلاج النفسي، وأعتقد أنني أصبحت معالجًا أفضل بذلك.